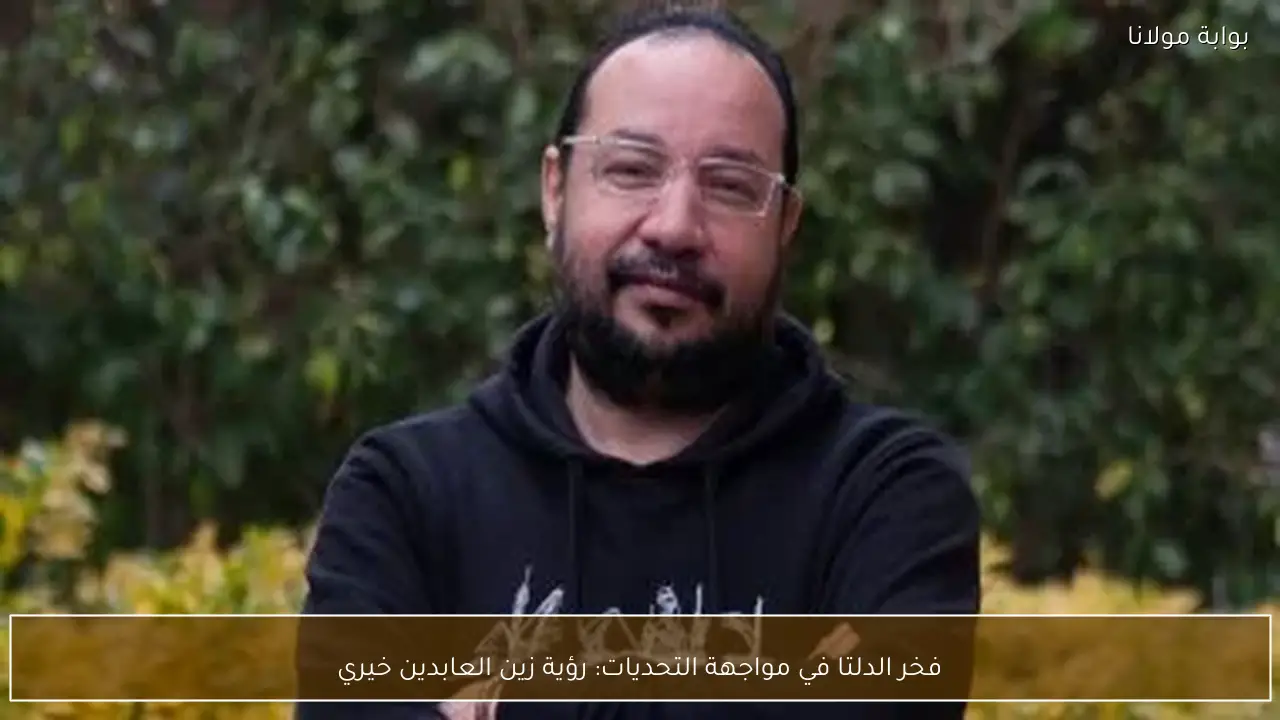تعتبر الشاشة الدرامية المصرية ركيزة أساسية في تشكيل الذاكرة البصرية والوجدانية للمجتمع على مر العقود، حيث تساهم في توثيق التحولات الاجتماعية وتعكس هويتنا الثقافية، وفي خضم هذا السياق، يواجه هذا الكيان الفني تحديات جديدة مع ظهور المنصات الرقمية، مما يفتح الباب أمام نوع جديد من الفن الهجين الذي يمزج بين إيقاع الفيديوهات القصيرة والبناء التقليدي للدراما التليفزيونية والسينمائية.
البداية وقصور الأدوات
تطورت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، حيث بدأت بعض الجهات الإنتاجية في استغلال شعبية مشاهير الإنترنت، وقد أظهرت هذه العملية تأثيرًا عميقًا على فلسفة الصناعة نفسها، حيث باتت الخوارزميات تفرض شروطها على اختيار الممثلين وصياغة السيناريو، مما أدى إلى استقطاب أسماء بارزة من منصات مثل “تيك توك” و”إنستجرام” ليتصدروا المشهد الدرامي، مثل محمود السيسي الذي ظهر في مسلسلات مثل “مكتوب عليا” و”طير بينا يا قلبي”، معتمدًا على شخصيته الرقمية المعروفة.
كما أثارت مشاركة شخصية مثل كروان في عمل درامي جاد مثل “بطن الحوت” ردود فعل نقدية وجماهيرية ملحوظة، بالإضافة إلى ظهور الطفل عبد الرحمن طه في مسلسل “الكبير أوي”، مما يعكس تباينًا في مهارات الأداء بين هؤلاء النجوم الجدد والممثلين المحترفين، حيث يتطلب فن التمثيل تقنيات متقدمة من المخزون الشعوري وقدرة على التحكم في الأداء، مما يبرز الفجوة بين هؤلاء الذين يكتفون بإضحاك الجمهور في لحظات قصيرة وبين متطلبات الدراما المستمرة.
من المهم هنا التمييز بين هؤلاء البلوجرز ومواهب حقيقية مثل طه دسوقي وعصام عمر، اللذين استخدما المنصات الرقمية كوسيلة لعرض مواهبهما، وهما ينتميان إلى مدرسة التمثيل المسرحي، حيث أثبتا جدارتهما عند منحهما الفرصة المناسبة.
فخر السوشيال واختلاف الظروف
في الموسم الرمضاني الحالي، تتجلى ظاهرة الفن الهجين بشكل أكثر تعقيدًا مع بطولة الشاب أحمد رمزي في مسلسل “فخر الدلتا”، الذي كتبه عبد الرحمن جاويش وأخرجه هادي بسيوني، حيث يواجه رمزي قامات تمثيلية مثل كمال أبو رية وخالد زكي وانتصار، مما يطرح تساؤلات حول قدرة رمزي على التكيف مع متطلبات الشخصية الدرامية.
تتميز حالة أحمد رمزي بخلفية أكاديمية نتيجة دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، مما يمنحه أدوات منهجية لفن التمثيل، ومع ذلك، فإن جماهيريته تعتمد على مقاطع ساخرة تركز على الإيقاع السريع، مما يثير تساؤلات حول مدى نجاحه في تقديم أداء درامي متكامل.
السؤال هنا يتعلق بقدرة المخرج هادي بسيوني على تجريد رمزي من ردود أفعاله السريعة، وصهر موهبته داخل شخصية ذات أبعاد إنسانية عميقة، خاصة مع التباين المتوقع بين الأداء المنضبط لمخضرمين مثل خالد زكي وكمال أبو رية والطاقة العفوية لنجم السوشيال ميديا، مما يشكل اختبارًا حقيقيًا لهذا الفن الهجين.
السادة الأفاضل نموذجًا
الأخطر من وجهة نظري أن يطال تأثير ظاهرة الفن الهجين جوهر السرد البصري وفلسفة المونتاج، فنشهد صعودًا مقلقًا لدراما “الريلز”، حيث يتجه صناع العمل لتصميم مشاهد قابلة للاقتطاع والنشر على منصات مثل “تيك توك” و”إنستجرام”، مما يقضي على الوحدة العضوية للعمل الفني
تجلت هذه الظاهرة بوضوح في فيلم “السادة الأفاضل”، الذي كتبته مجموعة من الكتّاب المتميزين، حيث قدم الفيلم تشريحًا ذكيًا لتعقيدات العلاقات الاجتماعية، ولكن بمجرد دخوله الفضاء الرقمي، تعرض لتشريح قاسٍ، رغم نجاحه في الوصول إلى جمهوره.
المشاهد السينمائية في “السادة الأفاضل” تتطلب من المشاهد استيعاب الصمت والنظرات المتبادلة، لكن تقطيعها إلى مقاطع قصيرة يجرّدها من سياقها الإنساني، مما يحول الأداء التمثيلي إلى وجبات بصرية سريعة، مما يفقد المتلقي فرصة التواصل الوجداني مع العمل.
البحث في سيكولوجية المتلقي المعاصر
تفرض هذه التحولات ضرورة البحث في سيكولوجية المتلقي المعاصر، حيث تتطلب الدراما الحقيقية استسلامًا واعيًا من المشاهد، بينما يفرض الإيقاع الرقمي حالة من الملل السريع، مما يعكس تنازلاً عن دور الفن كقائد للوعي المجتمعي.
واعتماد الأرقام الافتراضية كمعيار لتقييم الموهبة يمثل ظلمًا لأجيال من الممثلين الذين يفنون أعمارهم في صالات المسرح، بينما لا يملكون مهارات التسويق الذاتي.
على الرغم من أن ما أطرحه قد يبدو مبالغة، إلا أن الفن المصري قد يفقد بريقه عندما تتحول استوديوهات التصوير إلى امتداد لغرف مشاهير الإنترنت، مما يتطلب تجديدًا حقيقيًا يتماشى مع معايير الموهبة الحقيقية، حيث تمتلك الشاشة المصرية إرثًا عظيمًا يجب الحفاظ عليه.